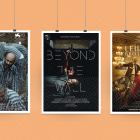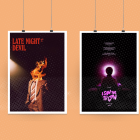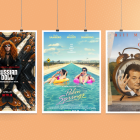فن
«هابي بيرث داي» .. جدل الأوسكار المصري بين فيلم لم يعرض وجمهور غاضب
ترشيح مثير للجدل بين الرفض والانحياز.. هل كانت مشاركة ممثلين أجانب وراء وصول «هابي بيرث داي» إلى الأوسكار رغم افتقاره إلى الابتكار البصري؟
 صورة من فيلم «هابي بيرث داي» المرشح لجائزة الأوسكار
صورة من فيلم «هابي بيرث داي» المرشح لجائزة الأوسكار
ترشيح مثير للجدل بين الرفض والانحياز
أثار فيلم «عيد ميلاد سعيد» (Happy Birthday) جدلًا واسعًا عقب ترشيحه ليمثل مصر في جائزة الأوسكار، متفوقًا على باقة من الأفلام المتميزة التي كان الجمهور قد شاهدها وتعلق بها. الجدل لم يكن فقط بسبب الاختيار نفسه، بل لأن الفيلم لم يُعرض جماهيريًا وقتها، الأمر الذي يخالف القواعد الأساسية التي تشترط العرض المحلي قبل الترشح. إدارة الفيلم فضّلت تأجيل عرضه في قاعات السينما انتظارًا لمشاركته في المهرجانات، إذ سيكون فيلم افتتاح مهرجان الجونة في دورته المقبلة في أكتوبر، وهو ما جعل صُنّاعه يتحفظون على الطرح الجماهيري المبكر.
لكن هذا القرار فجّر موجة اعتراضات واسعة، إذ اعتبر كثيرون أن الفيلم انتزع مقعد الترشيح من أعمال أخرى نالت حقها في العرض وتفاعلت معها الجماهير. فمن بين الأفلام التي كانت في القائمة: فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، الذي حمل روح محمد خان وأجواء الواقعية المصرية المحببة، وترك أثرًا قويًا لدى المشاهدين. كما كان هناك الفيلم التسجيلي البديع «رفعت عيني للسما»، الذي شارك في مهرجانات دولية وحصد إشادات واسعة، حتى أصبح أيقونة في المحافل السينمائية التي عُرض فيها.
من هنا جاء الهجوم على «عيد ميلاد سعيد»، لا بغضًا في العمل نفسه، بل انحيازًا للأفلام الأخرى التي شاهدها الجمهور وتأثر بها. وربما بدا غياب الفيلم عن شاشات العرض سببًا منطقيًا للغضب، لأنه ببساطة لم يُمنح المشاهد فرصة ليحكم عليه بنفسه.
وسط هذه الأجواء المليئة بالجدل، وجدت نفسي متحمسًا لمشاهدة الفيلم، ليس من باب الفضول فقط، بل لأن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح هو: هل يستحق هذا العمل فعلًا كل هذا؟ هل يحمل قيمة فنية عالية تؤهله لتمثيل مصر في الأوسكار؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب ألا يغيب وسط صخب الاعتراضات، فالقضية ليست فقط في شروط العرض أو الأولويات، بل في مدى جودة الفيلم نفسه وقيمته الفنية.
صدق العاطفة وضعف المغامرة البصرية
«هابي بيرث داي».. الفيلم، رغم الجدل الذي أحاط به، يقدّم معالجة إنسانية بالغة الصدق والعمق، إذ ينسج حكايته حول براءة الطفولة المسلوبة في مواجهة قسوة الواقع الاجتماعي، مستندًا إلى أداء تلقائي صادق وصورة بصرية تميل إلى البساطة الخالية من التكلّف، ما يمنحه قوة تأثير مباشرة. ومع ذلك، فإن هذا الميل إلى البساطة قد يُحسب عليه أحيانًا، إذ يضعه في منطقة مأمونة فنيًا لا تُخاطر كثيرًا بالابتكار البصري أو التجريب الشكلي، وهو ما يجعل قيمته كامنة أكثر في صدقه العاطفي ورسائله الإنسانية الواضحة، لا في ثورته الجمالية أو لغته السينمائية الجديدة.
يروي الفيلم حكاية الطفلة الصغيرة توحة، التي تعمل لدى أسرة مكوّنة من جدة وأم وابنتها، وهي في مثل عمرها تقريبًا. بعد انفصال الأم عن زوجها، يحلّ أول عيد ميلاد لابنتها، وبينما كانت الأم ترفض فكرة الاحتفال في البداية، تقرر لاحقًا إقامة الحفل لإثبات أن حياتها لا تزال تسير على ما يرام بعد الانفصال. هنا تلعب توحة دورًا محوريًا، إذ تشجع الأسرة بخططها الذكية على إقامة الحفل، متمسكة بحلمها في حضوره، خصوصًا بعدما أخبرتها الطفلة المدللة أن جميع الهدايا والألعاب ستكون لها متى تمنّت أمنية قبل إطفاء الشموع.
غير أن الأمور تأخذ منحى أكثر تعقيدًا؛ فمع دعوة الضيوف، تخشى الأم من أن وجود طفلة صغيرة تعمل لديهم كخادمة قد يسيء إلى صورتهم أمام العائلات الأخرى. لذا تطلب من والدة توحة أن تعود بها إلى البيت بحجة المرض، لتُحرم من حلمها البسيط. ومن هنا تبدأ رحلة توحة في محاولة الحضور لتحقيق أمنيتها، في مواجهة واقع اجتماعي قاسٍ يكشف عن الطبقية والعنصرية المتجذرتين في المجتمع الذي نعيش فيه.
القصة التي يقدّمها الفيلم عن الطفلة توحة تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها محمّلة بدلالات عميقة عن الطبقية والعنصرية الكامنة في تفاصيل الحياة اليومية. فوجود طفلة صغيرة تعمل خادمة لدى أسرة من نفس عمرها يفتح جرحًا اجتماعيًا صادمًا، ويكشف عن التناقض الفادح بين براءة الطفولة واستغلالها.
عيد الميلاد في حد ذاته يتحول إلى رمز فني بالغ الدلالة؛ لحظة يفترض أن تكون للاحتفاء بالطفولة والبراءة تتحول إلى مساحة إقصاء وتجميل للواجهة الاجتماعية أمام الآخرين، حيث تُستبعد توحة حتى لا تشوّه الصورة المصطنعة للعائلة. ومن هنا يكتسب الفيلم قوته، إذ يعرض عبر حكاية طفلة تتشبث بحلم بسيط ــ أمنية تُقال قبل إطفاء الشمع ــ مأساة طبقة كاملة تُحرم من أبسط حقوقها الإنسانية، في توازن بارع بين الحكي العاطفي والرمزية الاجتماعية.
بين «هابي بيرث داي» و«رفعت عيني للسما».. من الأجدر؟
يأتي فيلم «هابي بيرث داي» مربكًا وسط الزخم المعتاد والنبرة الحادة التي درجت عليها الأفلام التي تتناول قضايا كبرى، إذ يختار بدلًا من ذلك فكرة بسيطة وسردًا سلسًا وإخراجًا يبدو سهلًا ممتنعًا. ورغم بساطة القصة، فإنها تحمل دلالة إنسانية عميقة، تبرز من خلال كتابة محكمة إلى حد كبير، وأداء متقن للفتاة القائمة بدور توحة التي جسدت الشخصية بصدق لافت. كما حضرت الممثلة حنان مطاوع بأداء مؤثر رغم قِصر مساحة الدور، فيما جاء أداء بقية طاقم العمل جيدًا في مجمله.
في تقديري، كان «رفعت عيني للسما» الفيلم الأكثر استحقاقًا لتمثيل مصر في الأوسكار، ليس فقط لجودته الفنية، بل لأنه عمل مصري حتى النخاع، نابض بروح البيئة التي خرج منها. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن فيلم «هابي بيرث داي» يمتلك فرصًا كبيرة في المنافسة الدولية، بفضل الأسماء اللامعة خلف الكاميرا وعلى رأسهم محمد دياب الذي أصبح اسمًا عالميًا، فضلًا عن مشاركة ممثلين أجانب وداعمين مؤثرين في الإنتاج، ما يمنحه حظًا أوفر في سباق الأوسكار.
لكن، أيًا كان الفيلم الممثل لمصر، فالأهم أن يكون تمثيلًا مشرفًا يليق بتاريخ السينما المصرية، وهو ما سنقف جميعًا خلفه وندعمه في النهاية. وتثير القائمة التي ضمّت الأفلام المرشحة للأوسكار هذا العام ملاحظة لافتة، إذ إن نسبة معتبرة منها تمثل التجارب الإخراجية الأولى لصانعيها: «هابي بيرث داي» لسارة جوهر، «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» لخالد منصور، «الهوى سلطان» لهبة يسري، «رفعت عيني للسما» لندى رياض وأمين الأمير، و«جوازة في جنازة» لأميرة دياب.
هذه الظاهرة تستوقفنا وتدفعنا للتساؤل: هل هو مجرد مصادفة أن تتصدر أعمال البدايات المشهد، أم أن هناك تحوّلًا أعمق في طبيعة السينما المصرية يجعل من الجيل الجديد أكثر قدرة على التعبير عن اللحظة الراهنة بجرأة وصدق؟ لعل الأمر يعود إلى تعطش المشهد السينمائي لأصوات جديدة تكسر الرتابة وتقتحم مناطق مهملة، أو إلى حيوية التجربة الأولى نفسها بما تحمله من شغف وطاقة غير مقيّدة بالحسابات المعتادة.
ومهما يكن السبب، فإن هذه الموجة تدل بوضوح على أن المستقبل السينمائي في مصر يُكتب اليوم بأقلام المبتدئين، وأن قوة السينما تكمن في الدماء الجديدة القادرة على طرح الأسئلة وتحدي المألوف.
الخاتمة
في النهاية، يبقى حضور السينما المصرية في سباق الأوسكار حدثًا استثنائيًا يفتح باب النقاش حول ماهية الأفلام التي تستحق أن تحمل اسم مصر إلى العالم. فسواء وقع الاختيار على «هابي بيرث داي» أو «رفعت عيني للسما» أو غيرهما من الأعمال، فإن القيمة الحقيقية تكمن في أن لدينا جيلًا من المخرجين الشباب الذين ينجحون بأفلامهم الأولى في إثارة الانتباه عالميًا، ويدفعوننا إلى إعادة النظر في علاقتنا بالسينما كأداة تعبير عن الهوية المصرية في أبهى صورها. ولعل هذه المحاولات، بما فيها من جرأة وحساسية إنسانية، تؤكد أن الطريق إلى العالمية ليس حلمًا بعيدًا، بل نتيجة طبيعية للإبداع حين يلتصق بجذوره ويصغي إلى أسئلة واقعه بصدق ووعي.